مثل الابن الشاطر
الأرشمندريت توما(بيطار)
الأب، في المثل، هو الآب السماوي. والإبنان هما البشريّة. الناس على نوعين: نوع يَعرف أنّه خاطئ ونوع يظنّ أنّه بار. نوع يتوب ونوع مكتفٍ بما هو فيه.
هذا ينطبق على إسرائيل والأمم كما ينطبق على سائر شعوب الأرض. في كلّ حال البشريّة كلّها ساقطة.
“الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله” (رو 3: 23).
“ليس بار ولا واحد” (رو 3: 10).
الإنسان، حتى انطلاقاً من ناموس الطبيعة، قادرعلى أن يميّز، بعامة، الخير من الشرّ.
فإذا ما كانت نفسه، بتأثير من ذاته ومن تربيته ومن بيئته، مائلة إلى الخير فإنّه يعمل، أبداً، على إصلاح نفسه، وإذا ما كانت نفسه مائلة إلى البرّ الذاتي، للأسباب عينها، فإنّه قلّما يعمل على إصلاح نفسه إلاّ إذا تعرّض لآلام قاسية ربما هزّت منه الضمير.
طبعاً الحديث عن أنّ هناك ابناً أصغر وابناً أكبر ليس عَرَضاً. الأكبر هو البكر، هو إسرائيل، لأنّ الآب السماوي اختاره أوّلاً. هذا لازم أباه منذ البدء وبقي معه.
والابن الأصغر هو الأمم. هذا تركه الله، في الأجيال الماضية يسلك في طرقه (أع 14: 16). وليس ما يمنع، استطراداً، من اعتبار الأكبر مَن يلازم الكنيسة شكلاً في كلّ جيل، والأصغر مَن يستهويه العالم.
طلب الأصغر مغادرة أبيه. طلب أن يستقلّ. لا يريد، بعدُ، أن يكون تحت وصاية أبيه. الله، في الحسبان، عبء على الكثيرين. “أعطني النصيب الذي يخصّني من المال”. لا حاول أباه إقناعه بالعدول عن رأيه ولا منعه من الرحيل.
بعدما مالت نفس الإنسان إلى الخطيئة لم يعد بالإمكان حمايته. الخطيئة لا تَخضع للقناعات الفكريّة.
لها ناموسها الخاص. كذلك لا يمكن الإقفال على الإنسان في قفص لحمايته من الكواسر.
لذا قسم الأب معيشته بين ولديه. أعطى الأصغر نصيبه. أطلقه في الحرّيّة التي يطلب. تركه، ولو بألم، ينطلق في حرّيّة الخطيئة. أسلمه، عملياً، عن غير إرادة منه، لعبوديّة الخطيئة.
سافر إلى بلد بعيد. نأى عن أبيه. ظنّ أنّه كلّما بَعُدَ عن أبيه كلّما تسنّى له أن يتعاطى الحرّيّة أكثر. عاش في الخلاعة. لفظة “خلاعة” لا تشير إلى ما فعل بل إلى نتيجة ما فعل. السيرة التي سلك فيها جعلته مخلّعاً أي غير قادر، بعد، على ضبط حركات نفسه. صار مستأسَراً لخطاياه ولم تعد أهواء نفسه خاضعة للضوابط.
والخطيئة لا تُشبِع ولها ثمن. ليست مجّانيّة. وثمنها الجوع الكياني. كلّما تمادى الإنسان في خطاياه كلّما شعر بفراغ أكبر.
دفع الابن الأصغر ثمناً باهظاً عن خطيئته تمثّل في أمرَين: الجوع (الفراغ) والإذلال. الخطيئة، في نهاية المطاف، مذلّة. هذا تَمثّل برعاية الخنازير، على ما تُمثّل الخنازير من نجاسة في الوجدان.
كان هذا تأديبَه. تأدّب وعاد إلى نفسه. أبوه لم يؤدّبه. المحبّة لا تؤدِّب أحداً. ترك خطيئته تؤدِّبه. هذا يعني، استطراداً، أنّ الآب لا يدين أحداً. الخطيئة هي التي تحمل في ذاتها دينونة صاحبها.
“أجرة الخطيئة موت” (رو 6: 23).
الخطأة يموتون في خطيئتهم (يو 8: 21).
الله لا يميت أحداً. “لا يشاء موت الخاطئ إلى أن يرجع ويحيا”.
الخطيئة لا تحتمل المحبّة. محبّة الله عذاب لها. الخاطئ، في هذا الدهر، يتمتّع بخيرات الله لأنّ الربّ الإله ههنا “يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويَمطر على الأبرار والظالمين” (مت 5: 45).
هذا يتيحه الربّ الإله للذين يكفرون بأنعامه في هذا الدهر عساهم يرعوون ويتوبون. أما في الدهر الآتي فإنّ زمن التوبة يكون قد ولّى والخاطئ يعاني خطيئته كما هي في فراغها وظلمتها ونتانتها خالية من كلّ تعزية.
الله، في الدينونة، يغيب عن الخاطئ تماماً، لأنّ خطيئته لا مطرح فيها لمحبّة الله. هنا الأمور متداخلة. القمح والزؤان ينميان معاً. أما هناك فالقمح له مكان والزؤان له مكان آخر.
عاد الابن الأصغر إلى نفسه، تاب، فعاد إلى أبيه. الخطيئة، من حيث لا فضل لها، مدّته بمعرفة نفسه على حقيقتها وعلّمته التواضع. “أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقّاً بعد أن أُدعى لك ابناً”. وحده التواضع هو النضج الإنساني بعد السقوط. بعد السقوط لم يعد في طاقة الإنسان أن يكون صالحاً بل متواضعاً. “والقلب الخاشع المتواضع هذا لا يرذله الله”. هو رفع المتواضعين. هذه منّة منه. الخلاص نعمة مجّانيّة لا تُعطى إلاّ للمتّضعين. التواضع هو الطريق الملوكي.
تحنّن عليه أبوه وأسرع وألقى بنفسه على عنقه وقبّله. هذه شيمة الأب: حنان ولهف على عودة الضالين ومحبّة. لم يؤنّبه. لم يعيِّره. لم يدنه. فقط فرح به.
يكفي الخاطئ أن يدين نفسه حتى يبرّره الله. المظلوم الأكبر، في نهاية المطاف، هو الله. كم من ظلامة نتّهم الله بها وهو براء منها؟!
كيف استقبل الأب ابنه الأصغر العائد إليه؟ ألبسه الحلّة الأولى. ما هي الحلّة الأولى؟
حلّة البهاء والمجد، الحلّة الملوكيّة. تحلّى التائب المتواضع بالنور. وجعل خاتماً في يده. صار سيّداً. عبيد الله أسياد. هم يَستعبدون أنفسهم له كما استعبد هو نفسَه لهم بيسوع. لكنّهم في عينيه أحبّة وأبناء، إذاً سادة في المحبّة.
ثمّ دخل الابن الأكبر في الصورة. ما مشكلته؟ مشكلته، في العمق، هي الطمع. ظنّ أنّ أخاه سوف يقاسمه الميراث من جديد. ما قاله له أبوه دلّ على ما كان في نفسه: “كلّ ما هو لي هو لكَ”. والطمع جعله حسوداً. “لم تعطني قطّ جدياً لأفرح مع أصدقائي”.
جعله ديّاناً لأبيه. قال له بمعنى: “أخطأتَ في أحكامك!” الطمع جعله يتنكّر لأخيه. لما تكلّم على أخيه الأصغرعرّف عنه لدى أبيه هكذا: “ابنكَ هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني”.
كان كأنّه يعيِّر أباه: “أكرمت الزاني وأعرضت عن العفيف!” لم يعِ الابن الأكبر أنّه ساقط في البرّ الذاتي، أنّه ممتلئ من نفسه، أنّه يحسب نفسه بارّاً، أنّه يظنّ نفسه قدّيساً.
مَن هو الزّاني الحقيقي؟ الذي عاشر الزواني وتاب أم الذي عاشر الطمع والحسد والأنانية والكبرياء والتحف ببرّه الذاتي؟
ثمّ خدمة الابن الأكبر لأبيه. “كم لي من السنين أخدمك ولم أتعدّ لك وصيّة”؟
لم يفطن المسكين أنّ الطمّاع لا يخدم أحداً. يخدم نفسه. ولا يمكنه أن يخدم أحداً لأنّه لا يحبّ إلاّ نفسه. قلبه لم يكن يوماً لا إلى أبيه ولا إلى أخيه. الطمّاع يعتب على الله أنّه خلق غيره ويستصغر الله لأنّه في عين نفسه أكبر كبيراً.
ومع ذلك لم يفرزه أبوه ولا كان في نيّته فرزه عنه: “أنت معي في كلّ حين”. كيانياً الابن الأكبر هو الذي فرز نفسه عن أبيه والعالم. لم يحسب اللهَ والعالمَ مستحقّاً له!
المشكلة الكبرى ليست مشكلة الابن الأصغر بل الابن الأكبر. الابن الأصغر خطئ وعاد، أما الابن الأكبر فلا عودة له،
كيف يعود وهو يظنّ أنّه على صواب وأنّ أباه هو الذي أخطأ؟
الضال، في الحقيقة، ليس الابن الأصغر. هذا كان ضالاً فوُجد وكان ميتاً فعاش. أما الضال المقيم راسخاً في ضلاله فهو الابن الأكبر. هذا حسب نفسه حيّاً وهو ميت، روحيّاً ميت.
من جهة الناس حالُ الابن الأكبر يائسة. نرجو ألاّ يكون الأمر كذلك من جهة الله. أقول هذا وأنا أرى في نفسي ونفوس الكثيرين ممَن حسبوا أنفسهم لله لا فقط لطخات من سيرة الابن الأصغر بل شيئاً أو الكثير من إرث الابن الأكبر!



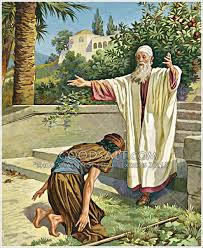
















Discussion about this post