وقد سأل يوماً أحد الكتبة يسوع عن أولى الوصايا، فأجابه يسوع مردّداً كنت العهد القديم: “أُولى الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل: الرب إلهنا هو الرب الوحيد. فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قوّتك” (مر 12: 29، 30؛ راجع تثنية الاشتراع 6: 4، 5).
وللتعريف بهذا الإله لا يلجأ يسوع إلى لغة فلسفية وتعابير نظرية تصف الله في ذاته، بل يستخدم، على مثال أنبياء العهد القديم، لغة حياتية وتعابير واقعية وأمثالاً شعبيّة لا تعرّف بالله في ذاته بقدر ما تعرّف به في علاقته بالعالم والانسان. فيبدو الله، في تعاليم يسوع، قريباً من العالم والانسان، على خلاف آلهة الفلاسفة الأقدمين.
فالله، عند أفلاطون، هو الفكرة المطلقة المجرِّدة للخير، وهو بعيد كل البعد عن هذا العالم، عالم الظواهر الحسية والمادة الفاسدة. وينتج من تلك النظرة إلى الله موقف عداء للمادة ورذل للجسد.
والله، عند أرسطوطاليس، وان كان قد أبدع الكون، إلا أنه يحيا منذ الأزل بعيداً عن الكون. فهو العقل الذي يعقل ذاتَه ولا يبالي بالعالم: لا علاقة له بشؤون البشر، فلا يعتني بهم ولا يطلب منهم شيئاً. والله، عند أفلوطين، هو الواحد المنفصل عن الكون، الذي منه انبثق عالم المادة. إلا أن العالم، بانبثاقه من الواحد، سقط في فساد الكثرة والتعدّدية.
لذلك، بينما الإله الواحد هو إله الخير، لا يرى أفلوطين في المادة إلا الشر والفساد. ويتحتّم من ثم على الانسان الذي يريد الوصول إلى الله أن يبتعد عن المادة ويتحرّر منها. 2- الإله القريب من الانسان هذا التناقض بين الله والكون لا وجود له في العهد القديم ولا في تعليم يسوع.
فالله، منذ العهد القديم، هو الذي خلق الكون والمادة وخلق الانسان روحاً وجسداً، “ورأى ذلك كله انه حسن”. وبعد أن خلق الكون والانسان لم يتخلَّ عنهما بل بقي ملتزماً ما خلق. فهو سيّد التاريخ وسيّد الانسان، وهو الذي يقود البشرية جمعاء إلى الخلاص. وقد أعلن للانسان مشيئته القدوسة في ما رسم له من أحكام ووصايا، وطلب منه الطاعة لأحكامه والأمانة لوصاياه.
ومهما ابتعد الانسان عن الله، يبقى الله قريباً من الانسان يخاطبه ويذكّره بعهده ووصاياه، تارة في كلام الأنبياء وطوراً من خلاله أحداث التاريخ، يلاطفه مرّة ويداعبه، ويؤنّبه مرّة ويقاصّه. هذا الإله يصوّره لنا الكتاب المقدّس منذ سفر التكوين في ملامح بشرية. فنراه يتكلم ويأمر ويَعِد ويهدّد ويقاصّ ويسامح ويتطلّب ويغار ويغضب ويندم، يشعر بالفرح والحزن، بالمحبة والكره. لا تعني تلك التصاوير البشرية أن الله هو على مثال الانسان في تقلُّب عواطفه وتغيّر طبعه ومزاجه.
فالقصد منها إظهار قرب الله من الانسان وعنايته الدائمة به وغيرته المستمرة عليه. فالله ليس كائناً مبهماً ولا حقيقة مجرّدة. وليس هو بالفراغ المظلم الذي لا يمكن التعريف به ولا الهاوية التي لا يمكن تحديدها. الله في تعليم يسوع، كما في العهد القديم، يظهر لنا كائناً شخصياً يمكن التحدّث إليه، وكائناً حياً أعطى الحياة للإنسان، وكائناً محباً يعتني بالبشر كما يعتني الأب بأبنائه.
وهذا الكائن الشخصي الحي المحب هو الذي أخذ المبادرة وأوحى بنفسه إلى الانسان داعياً إياه إلى أن ينشى معه علاقات شخصيّة وحيّة، وعلاقات محبة. فالله هو الذي يقترب من الانسان ويريد أن يقترب منه الانسان بثقة ومحبة فيخاطبه ويتحدث إليه في الصلاة داعياً شاكراً ساجداً مبتهلاً.
ومن خلال تلك العلاقات يريد الله من الانسان أن يزيل من نفسه كل خوف وقلق يمكنه أن يشعر بهما في هذا العالم، ويثق بالله ثقة الصديق بصديقه ويحبه محبة الابن لأبيه. لذلك لا نجد لا في العهد القديم ولا في تعاليم يسوع براهين فلسفية عن وجود الله. فيسوع لا ينطلق من الكون والانسان ليبرهن من خلالهما عن وجود الله. إلاّ أنه عندما يتكلم عن الكون والانسان يظهرهما دوماً مرتبطين بكائن آخر هو مبدأ كيانهما وثبات وجودهما.
لا يرى يسوع العالم إلا في نور الله، فاذا به عالم حسن يستطيع الانسان، دون خوف وقلق، أن يحقّق فيه ذاته ويصل من خلاله إلى سعادته وغاية وجوده. وهكذا يظهر وجود الله في تعليم يسوع جواباً ليس على رفض الملحدين ولا على فضولية علمية تحاول تقصّي أسرار الكون، بل على حاجة وجودية كامنة في أعماق كيان الانسان. فالله، في نظر يسوع، لا يهمل الناس بل يعتني بهم جميعاً كما يعتني بطيور السماء وزنابق الحقل.
لذلك يجب على الانسان ألاّ يعيش في الخوف والقلق والاضطراب. وهذا معنى عدم الاهتمام المفرط بأمور الحياة الذي يطلبه يسوع بقوله:
“لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام، والجسد أعظم من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، فإنها لا تزرع ولا تحصد، ولا تجمع إلى الأهراء، وأبوكم السماوي يقوتها؛ أفلستم أنتم أفضل منها بكثير؟ مَن منكم يستطيع، مع الجهد، أن يزيد على عمره ذراعاً واحدة؟ ولماذا تقلقون بشأن اللباس؟ تأمّلوا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل؛ وأنا أقول لكم: ان سليمَان نفسه، في كل مجده، لم يلبس كواحدة منها. فاذا كان عشب الحقل، الذي يكون اليوم، ويُطرَح في التنّور غداً، يلبسه الله هكذا، فكم بالأحرى يلبسكم أنتم، يا قليلي الايمان؟ فلا تقلقوا إذن قائلين: ماذا نأكل؟ أو: ماذا نشرب؟ أو: ماذا نلبس؟ فهذا كله يطلبه الوثنيون، وأبوكم السماوي عالم بأنكم تحتاجون إلى هذا كله. بل اطلبوا أولاً ملكوت الله وبرّه، وهذا كلّه يُزاد لكم”.(متى 6: 25- 34) وهذا ما يعنيه يسوع أيضاً في مَثَل القاضي الجائر الذي كانت تأتي إليه أرملة قائلة:
أنصفني من خصمي. “فامتنع زماناً طويلاً، ثم قال في نفسه: اني وإن كنت لا أتّقي الله، ولا أرعى للناس حرمة، أنصف هذه المرأة بما أنها تبرمني، لئلا تعود، على غير نهاية وتوجع رأسي”. ثم قال الرب: “اسمعوا ما يقول القاضي الجائر! والله، ترى، أفلا ينصف مختاريه الذين يصرخون إليه نهاراً وليلاً؟ وهل يتوانى عنهم؟ أقول لكم: انه ينصفهم سريعاً”.(لوقا 18: 4- 8) ويشبّه يسوع الله بالأب الذي يعرف أن يعطي العطايا الصالحة لأولاده:
“إسألوا فتعطوا، اطلبوا فتجدوا، إقرعوا فيفتح لكم. فإن كلّ من يسأل يُعطى، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يُفتح له. أي إنسان منكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجراً؟ أو يسأله سمكة فيعطيه حيّة؟ فاذا كنتم، مع ما أنتم عليه من الشرّ، تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأولادكم، فكم بالأحرى أبوكم الذي في السماوات يمنح الصالحات للذين يسألونه!”(متى 7: 7- 11)
في تلك التصاوير والتشابيه والأمثلة يجد الانسان الجواب على ما يلاقيه في حياته من صعوبات ومضايق: في الشدّة والعذاب، في الضيق والألم، في الحزن والحرمان، يعلم أن الله لا يهمله، بل هو قريب منه، وانه باستطاعته في كل لحظة أن يلتجئ إلى الله فيجد الراحة والسلام والفرق والحياة. لم يأتِ يسوع ليشبع فضولية الانسان ويكشف له عن أسرار الكون، بل جاء ليعطيه موقفاً جديداً من الحياة، موقف إيمان بأن الحياة هي عطية من الله الأب المحبّ القريب من الانسان.3- إله الملكوت إنّ قُرب الله من الانسان قد تحقق بشكل خاص بمجيء الملكوت في شخص يسوع المسيح. كان اليهود في العهد القديم ينتظرون زمناً يملك فيه الله على البشر ملكاً مباشراً فيزيل من الأرض الشقاء والظلم، ويحيا الناس متّحدين اتحاداً صميماً بالله الحاضر في العالم حضوراً دائماً ومتمّمين على الدوام إرادته المقدسة.
عندما باشر يسوع كرازته بدأها بالتبشير مجيء الملكوت: لقد تمّ الزمان واقترح ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. والأدلّة على قرب الملكوت أعطاها يسوع في ما اجترح من معجزات. ففي نقاش مع الفريسيين قدّم لهم يسوع معجزاته دليلاً على قرب الملكوت:
“اذا كنت أنا بروح الله أُخرج الشياطين، فقد اقترب منكم ملكوت الله” (متى 12: 28). وبينما كان يوحنا المعمدان في السجن أرسل اثنين من تلاميذه يسألان يسوع: أأنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجابهما يسوع: “انطلقوا وأعلِموا يوحنا المعمدان بما تسمعون وترون: العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصمّ يسمعون والموتى ينهضون والمساكين يبشّرون وطوبى لمن لا يشكّ فيّ” (متى 11: 4- 6).
كل تلك المعجزات هي آيات، أي أعمال رمزية تظهر حضور الله وعمله في العالم بشكل نهائي في شخص يسوع المسيح، وتدعو الناس إلى الايمان بالمسيح ودخول الملكوت. ولا يستطيع أحد أن يلاقي الله ويدخل ملكوته إلا بتجديد حياته. فالسامرية والمرأة الزانية وزكّا العشّار ونيقوديمس ومتى العشّار وبطرس، جميعهم دخلوا الملكوت عندما آمنوا أن الله قد حضر اليهم في شخص يسوع.
التقوا الله في الايمان بالمسيح ومن ثم جدّدوا حياتهم ليحيوا حياة الله فيهم. قلنا في الفقرة الثانية إن يسوع لا يبرهن عن وجود الله فلسفياً بل يرى كل شيء في نور الله، فيبدو وجود الله أساساً لوجود الكون ووجود الانسان.
نضيف هنا أن الله ليس وهماً ولا صنع مخيّلة البشر ولا انعكاساً لرغباتهم كما يدّعي الملحدون من أمثال وماركس وفويرباخ فالله، في نظر يسوع حقيقة تسبق الانسان وكائن لا يستسلم لرغبات الانسان بل يدعوه إلى تجديد حياته للولوج إلى حياة الله. وقد أصبح ذلك ممكناً بمجيء المسيح. ان الله الذي هو قريب من الانسان منذ أن خلقه، والذي التزم محبة الانسان منذ أن أوجده، قد أصبح حاضراً في الكون ومع الناس حضوراً خاصاً ومميّزاً في شخص يسوع المسيح. ففي المسيح يسوع يملك الله على البشر لا كما يملك ملك على عبيده، بل لا يملك الحق في قلب عاشق الحق.
وفي المسيح يسوع يحيا الناس مع الله، لا كما يحيا عبيد مع أسيادهم بل كما يحيا أبناء مع أبيهم. فبيسوع ابن الله يستطيع الجميع أن يصبحوا أبناء الله. “لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة، مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس وننال التبنّي” (غلا 4: 4، 5)،
“وكل الذين قبلوه آتاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء الله” (يو 1: 12). لذلك في العهد الجديد يبدو لنا الله إله والملكوت وإله النعمة والرحمة في آن واحد. 4- إله النعمة والرحمة “إن الناموس قد أُعطي لنا بموسى، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد حصلا” (يو 1: 17). إن قمة كشف الله عن ذاته في العهد القديم هي في ظهوره لموسى على جبل سيناء. فهناك أبرم الله عهداً مع بني اسرائيل وهناك أعطاهم الناموس ووعدهم بأن يكون معهم إن حفظوا وصاياه.
وأصبح الناموس في العهد القديم الطريق الذي يقود الانسان إلى الله. أما في العهد الجديد فالله ليس إله الناموس بل إله النعمة والرحمة. وهذا ما أظهره يسوع في عمله وفي تعليمه. فنراه ينقض الناموس ليجري الأشفية يوم السبت، فيشفي اليابس اليد (متى 12: 1- 14)، والمرأة الحدباء (لوقا 13: 10- 17)، ويرفض أن تطبّق شريعة موسى القائلة برجم المرأة الزانية ويستبدلها بالرحمة والمغفرة (يو 8: 3- 11).
لقد أظهر يسوع بنوع فائق رحمة الله للخطأة. “فكان العشّارون والخطأة جميعاً يقبلون إليه ليسمعوه، ما جعل الفريسيين والكتبة يتذمّرون قائلين: ان هذا الرجل يقبل الخطأة ويأكل معهم” (لوقا 15: 1، 2). فيغفر لمخلّع كفرناحوم: “يا رجل مغفورة لك خطاياك”، ثم يشفيه: “لك أقول: قمْ واحمل فراشك وامضِ إلى بيتك” (لوقا 5: 17- 26). وفي بيت سمعان الفرّيسي يغفر للمرأة الخاطئة التي جاءت إليه تبكي وتبلّ رجليه بالدموع وتمسحهـا بشعر رأسها، ويقول لسمعان: “إن خطاياها، خطاياها الكثيرة، مغفورة لها، بما أنها أحبّت كثيراً” (لوقا 7: 36- 50).
ويغفر لزكّا العشّار قائلاً: “اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت، فإنه هو أيضاً ابن لابراهيم. لأن ابن البشر قد جاء ليطلب ما قد هلك ويخلّصه” (لوقا 19: 1- 10). وتفسيراً لموقفه من الخطأة يصف في عدة أمثال موقف الله نفسه من الخطأة.
وقد جمع لوقا في الفصل الخامس عشر من إنجيله ثلاثة من هذه الأمثال: الخروف الضالّ والدرهم المفقود والابن الشاطر.
أ- مَثَل الخروف الضالّ فالله يشبه الراعي الصالح الذي لا يرضى بأن يهلك أحد من خرافه، “فاذا كان له مئة خروف وأضاع واحداً منها، يترك التسعة والتسعين في البرّية ويمضي في طلب الضالّ حتى يجده، واذا ما وجده يحمله على منكبيه فرحاً، ويعود إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران ويقول لهم: افرحوا معي، فإني قد وجدت خروفي الضالّ”. ثم يردف يسوع منتقداً الفريسيين والكتبة الذين كانوا يتذمّرون لقبوله الخطأة ومؤاكلتهم، ومنتقداً الصورة المشوّهة التي كانوا يرون الله من خلالها:
“أقول لكم: هكذا في السماء يكون فرح بخاطئ يتوب أكثر ما يكون بتسعة وتسعين صدّيقاً لا يحتاجون إلى توبة” (15: 4- 7). ويعني بهؤلاء التسعة والتسعين الفريسيين الذين يعتقدون أنهم صدّيقون وأنهم ليسوا بحاجة إلى توبة (راجع في ذلك مَثَل الفريسي والعشّار، لوقا 18: 9- 14).
ب- مَثَل الدرهم المفقود والله يسعى أيضاً وراء الخاطئ كما تسعى المرأة الفقيرة وراء درهم أضاعته من دراهمها العشرة، “فتوقد سراجاً وتكنِّس البيت، وتطلبه في اهتمام حتى تجده؛ واذا ما وجدته تدعو الصديقات والجارات وتقول لهنّ: افرحن معي، فاني قد وجدت الدرهم الذي أضعت”. ثم يضيف يسوع: “أقول لكم، إنه هكذا يكون الفرح عند ملائكة الله بخاطئ يتوب” (15: 8- 10).
ج- مَثَل الإبن الشاطر أو الأب الرحيم أما قمّة الوحي الانجيلي بصورة الله فنجدها في مَثَل الإبن الشاطر. فالله الملك يصبح الله الأب، وعلاقة الله مع الناس لم تعد علاقة ملك مع عبيده، بل علاقة أب مع أبنائه، الخطأة والصدّيقين، الأشرار والصالحين.
فالله هو ذلك الأب الذي ينتظر عودة ابنه الأصغر الذي أخذ حصّته من الميراث وقصد إلى بلد بعيد وأتلفها هناك عائشاً في التبذير. ولدى عودته، “وإذ كان بعد بعيداً، أبصره أبوه، فتحرّكت أحشاؤه وبادر إليه وألقى بنفسه على عنقه وقبَّله طويلاً” (15: 20). ولما أراد الابن أن يعتذر عمّا صنعه، قائلاً: “يا أبتاه، قد خطئت إلى السماء وإليك، ولا أستحقّ بعد أن أُدعِى لك ابناً” قاطعه الأب قائلاً لغلمائه: “هلمّوا سريعاً بأفخر حلّة وألبسوه وضعوا في يده خاتماً وفي رجليه حذاء، وأْتوا بالعجل المسمَّن واذبحوه، ولنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش، وكان ضالاًّ فوُجِد” (15: 22- 24).
يجب أن يدعى هذا المَثَل، لا مَثَل “الإبن الشاطر”، بل مَثَل “الأب الرحيم”، لأنه لا يركّز على موقف الإبن الشاطر بقدر ما يركّز على موقف الأب من ابنه الأصغر ثم من ابنه الأكبر. فالأب يغفر لابنه الأصغر ويعيده إلى بيته مكرَّماً، ثم يدعو ابنه الأكبر الذي يغضب ويرفض الدخول إلى البيت، إلى مشاركته الفرح بعودة أخيه الأصغر “الذي كان ميتاً فعاش وكان ضالاًّ فوُجِد” (15: 32).
فالابن الأكبر يمثِّل الفريسيين في كبريائهم وقسوتهم تجاه موقف يسوع من الخطأة. كل ما عرَف الابن الأكبر عن أبيه الخدمة والأوامر. فيقول لأبيه: “كم لي من السنين في خدمتك، ولم أتعدَّ قط أمراً من أوامرك” (15: 29). وكل ما عرف الفريسيون عن الله الناموس والوصايا. ولكن الله، في نظر يسوع، ليس إله الأوامر والنواهي والناموس والوصايا، بل الله هو إله الرحمة والمحبة، وبقدر ما يبتعد أبناؤه عنه، بقدر ذلك تزيد محبته لهم.
وهذا ما لم يستطع أن يفهمه الفريسيون المتعلقون تعلُّقاً أعمى بحرف الناموس. الله، في نظر يسوع، ليس إله الكبت والضغط والإكراه، بل إله التحرّر الذي يحرّر الانسان من حواجز التقاليد الاجتماعية والأحكام البشرية التي تفصل السامريين عن اليهود والعشّارين عن الفريسيين، وتغلق على الخطأة في خطيئتهم وعلى المنبوذين في انتباذهم وعلى المحرومين في حرمانهم وعلى الضعفاء في ضعفهم. الله، في نظر يسوع، هو إله الممكنات الذي يفتح أمام الانسان آفاق المستقبل، فيحرّره من قيود نفسه ويدعوه إلى تجاوز ذاته باستمرار؛ الله فيض من العطاء المجاني لا نستطيع أن ندرك عمقه أو سعة امتداده.
والايمان بهذا الإله لا يستطيع الانسان أن يصل إليه عن طريق التحليل الفكري بل عن طريق الاختبار الشخصي. ان الإله الحقيقي قد ظهر لنا في شخص يسوع المسيح. والرسل والتلاميذ الذين آمنوا بيسوع وعاشوا معه اختبروا من خلاله الله وعرفوا وجهه الحقيقي.
وعندما أراد يوحنا الانجيلي أن يعرّف بالله كما ظهر له من خلال تعاليم يسوع وحياته، ومن خلال خبرته الشخصية وخبرة سائر الرسل، لم يجد أجمل وأعمق وأصدق من هذا التعبير : “ان الله محبة” (1 يو 4: 16). 5- كمال الله في كمال المحبة في نهاية الفصل الخامس من انجيل متى، يطلب يسوع من مستمعيه أن يتشبّهوا بكمال الله: “فأنتم اذاً كونوا كاملين كما أنّ أباكم السماوي هو كامل” (متى 5: 48). قد يتبادر إلى أذهاننا أن كمال الله هو في قدرته المطلقة على كل شيء، وعلمه الكامل بكل شيء، وتنزّهه عن المادة، وأزليته التي لا يستطيع أحد أن يدرك مداها، وعدم تحوّله وتغيّره. ونتساءل: كيف يسعنا، نحن البشر الضعفاء المحدودين في الوجود والمعرفة، أن نتشبّه بكمال الله؟
ان يسوع يعلم ضعف البشر وحدودهم، ومع ذلك يطلب منهم أن يكونوا كاملين مثل الله. ذلك لأنه أوجز جميع صفات الله في صفة واحدة هي في متناول الانسان، وتلك الصفة هي المحبة: “سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوّك. أما أنا فأقول لكم: أحبّوا أعداءكم، وصلّوا لأجل الذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فانه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والأثمة. فإنكم إن أحببتم من يحبكم فأيّ أجر لكم؟ أليس العشّارون أنفسهم يفعلون ذلك؟ وإن لم تسلِّموا إلاّ على اخوانكم فقط، فأيّ عمل خارق تصنعون؟ أوَليس الوثنيون أنفسهم يفعلون ذلك؟ فأنتم إذن كونوا كاملين كما أنّ أباكم السماوي هو كامل”.(متى 5: 43- 48)
لن يصل الانسان إلى كمال الله، في نظر يسوع، إلا بالتشبّه بمحبة الله الشاملة لجميع الناس. “قل لي مَن هو إلهك، أقُل لك مَن أنت”. إلهنا محبة، فينبغي أن نكون نحن محبة. والله هو الذي بادرنا بالمحبة. وانطلاقاً من تلك المحبة التي أحبَّنا، يطلب منا أن نحبّ بعضنا بعضاً. بهذا فقط نستطيع أن نصل إلى الله: “ان الله محبة، فمن ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه” (1 يو 4: 16). ان الله قد أحبّنا أولاً وغفر لنا خطايانا.
فنحن البشر كلنا نشبه ذلك العبد الذي قُدِّمَ إلى سيّده وعليه عشرة آلاف وزنة، وإذ لم يمن له ما يوفي به، تحنّن عليه سيّده وترك له الدَّين. (راجع المَثَل في متى 18: 21- 35). وكما غفر لنا الله دون حدّ، كذلك يطلب منا أن نغفر بعضنا لبعض زلاّتنا، وذلك ليس فقط إلى سبع مرّات بل إلى سبعين مرّة سبع مرات أي دون أي حد.
أ- صفات الله بهذا تتميّز المسيحية عن سائر الديانات، في نظرتها إلى الله. ان إله المسيحية لم يخترعه المسيحيون كما يدّعي الملحدون. فالله هو الذي أظهر لنا ذاته في شخص يسوع وتعليمه. وقد ظهر لنا محبة متجسّدة. فالمحبة هي التي تحدّد الله في المسيحية وانطلاقاً من هذا التحديد تأخذ صفات الله التي تتحدّث عنها الفلسفة ومختلف الديانات معاني جديدة: فأزلية الله لا تعني ابتعاده عن الزمن، بل حضور محبته حضوراً دائماً ومعاصراً لجميع الأزمنة. وروحانيته لا تعني تنزّهه عن المادة الفاسدة، بل سلطته المطلقة على الخليقة كلها وشمول محبته الكون بأسره؛ فالروح يهبّ في كل مكان ولا يستطيع أحد أن يوقف عمله. وصلاحه ليس إشعاعاً طبيعياً لما فيه من خير بقدر ما هو عمل اختيار عطوف ومحبة حرة. وعدم تحوّله لا يعنى الجمود بل الأمانة الكاملة لذاته ولمحبته.
وعدله لا يعني مجازاة كل واحد بحسب أعماله وفقاً لنظام لازمني، بل هو فيض من المحبة والرأفة والخلاص. وعدم ادراكنا له لا يعني اننا أمام كائن مبهم وحقيقة غامضة، بل ان الله يسمو على كل ما يستطيع الانسان أن يتصوّره، وان محبته لا يمكن أحداً أن يسبر عمقها، حسب قول بولس الرسول: “يا لعمق غنى حكمته وعلمه! ما أبعد أحكامه عن التنقيب وطرقه عن الاستقصاء! فمن عرف فكر الرب؟ ومَن كان له مشيراً؟ من سبق فأعطاه، فيردّ اليه؟ ان كل شيء هو منه وبه وإليه. فله المجد إلى الدهور، آمين”(روم 11: 33- 36).
ب- المحبة حتى الموت ولقد ظهرت محبة الله في أقصى حدودها في موت يسوع على الصليب: “فانه هكذا أحبّ الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية” (يو 3: 16). فالله الآب بذل ابنه لأجل العالم. ويسوع ابن الله بذل ذاته لأجل العالم متمماً ما قاله لتلاميذه: “ليس لأحد حبّ أعظم من أن يبذل الحياة عن أصدقائه”. (يو 15: 13). والابن في بذل ذاته حتى الموت هو صورة لله الآب: “مَن رآني فقد رأى الآب” (يو 14: 9). ان يسوع المسيح هو صورة لله الآب ليس فقط في حياته ومعجزاته وموقفه تجاه الخطأة، بل أيضاً وبنوع خاص في موته.
فالابن في محبته لنا حتى الموت هو صورة حقيقية للآب الذي أحبنا حتى أقصى حدود المحبة. يتصوّر البعض أن يسوع على الصليب قد سكَّنَ غضب الله الثائر على البشر من جرّاء خطاياهم. ان هذا التصوّر البشري بعيد كل البعد عن الموقف الالهي. فيسوع في بستان الزيتون كان يخاطب الله قائلاً: “يا أبتاه، إن شئتَ فأَجزْ عني هذا الكأس. ولكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك” (لوقا 22: 42).
الكأس هنا هي كأس العذاب ولكنها في الوقت نفسه كأس الخلاص. ومشيئة الله ليست في الانتقام من الخطأة بل في خلاصهم وتبريرهم. ويسوع في وسط عذابه يستعمل لفظة يا أبتاه (بالعبرية “أبّا”)؛ ففي لحظة عذابه وموته، كما في كل حياته، نرى ان إرادته متّحدة بإرادة الله الآب لخلاص البشر بالمحبة حتى الموت في سبيلهم. ان حوار يسوع مع أبيه في بستان الزيتون يذكّرنا بحوار اسحاق مع أبيه ابراهيم عندما أصعده ابراهيم إلى جبل موريّا ليقدّمه ذبيحة لله: “فكلّمَ اسحاق ابراهيم أباه وقال: يا أبتاه! قال: لبّيك يا بُنيّ! قال: هذه النار والحطب، فأين الحَمَل للمحرقة؟ فقال ابراهيم: الله يرى الحَمَل له للمحرقة يا بُنيّ. ومضيا كلاهما معاً” (تكوين 22: 7، 8). إن إله ابراهيم ليس إلهاً سفاحاً كآلهة الوثنيين العطشى إلى دم البشر، وإله يسوع كان بإمكانه أن يرسل لنصرته اثنتي عشرة جوقة من الملائكة.
ولكن إله يسوع، كإله ابراهيم، ليس إله الحرب والقتل والدمار، إنه أب لإبن وحيد. وهذا الابن قد أسلمه لأجلنا نحن، حسب قول بولس الرسول: “اذا كان الله معنا، فمَن علينا؟ هو الذي لم يشفق على ابنه الخاص بل أسلمه عنا جميعاً، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟” (روم 8: 31، 32). بموت يسوع ظهرت صورة الله الحقيقية.
فالله ليس إله القدرة والتسلّط والعظمة والانتقام. إنه إله العطاء والمحبة الذي بذل ابنه الوحيد للموت ليظهر للبشر محبته لهم ويمنحهم الفداء والخلاص. إلا أن الموت ليس نهاية كل شيء. فالله الذي أظهر أقصى محبته للعالم ببذل ابنه إلى الموت لأجل حياة العالم، أظهر أيضاً أقصى محبته لابنه وللعالم بإقامته يسوع من بين الأموات وإدخاله البشرية إلى مجده السماوي. “فالله ليس إله أموات، بل إله أحياء” (متى 22: 32).
ثم “ان المسيح قد قام من بين الأموات، باكورة للراقدين” (1 كور 15: 20). 6- الله والانسان هل انكشف لنا، من خلال ما قلناه، وجه الله الحقيقي؟ لربما لم يتضح لنا وجه الله في ذاته بقدر ما اتضح لنا وجه الله في علاقته بالانسان. فالله في ذاته لا يستطيع انسان أن يراه ويبقى حياً. اننا نبقى إزاء سرّ الله كموسى الذي ظهر له الله على جبل سيناء فطلب إليه أن يريه وجهه فقال له الله: “لا يستطيع انسان أن يراني ويبقى حياً”.
لم يقدر موسى أن يشاهد وجهه، لكنه شاهد مجده أي بعضاً من حضوره، لم يعرف موسى الله إلا من خلال عمله. فلما أخرج الله شعبه من عبودية مصر، عرف موسى ان الله هو إله الخلاص والمحبة والحرية.
أ- يسوع المسيح طريق الانسان إلى الله هكذا في العهد الجديد أيضاً عرفنا الله من خلال ابنه يسوع الذي هو حضور الله بالجسد. جميع الذين يؤمنون بالإله الواحد يعترفون بأن الله هو خالق الكون وخالق الانسان.
وجميع الذين يؤمنون بالوحي يعترفون بأن الله قد أوحى بذاته للانسان بواسطة أنبيائه ومرسليه. إلا أن الإيمان بالإله الواحد يتَّسم في المسيحية بسِمَة خاصة. فإله الكون وخالق الدنيا الذي يؤمن بوجوده المسيحيون والمسلمون واليهود معاً هو، تبعاً للإيمان المسيحي، إله المحبة الذي لم يكتفِ بإظهار وجوده في الكون والطبيعة
وإعلان إرادته لبعض الأنبياء المختارين كإبراهيم وموسى عند اليهود ، بل ظهر شخصياً في تاريخ البشر وأوحى بذاته في شخص ابنه وكلمته يسوع المسيح، ليشرك البشر جميعاً في حياته الالهية. “ان الله، بعد إذ كلَّمَ الآباء قديماً بالأنبياء مراراً عديدة وبشتى الطرق، كلَّمنا نحن، في هذه الأيام الأخيرة، بالإبن الذي جعله وارثاً لكل شيء كما وبه أيضاً أنشأ العالم، الذي هو ضياء مجده، وصورة جوهره، وضابط كل شيء بكلمة قدرته”.(عبرانيين 1: 1- 3)
بهذا يتميّز الايمان المسيحي عن إيمان اليهودية والاسلام: “ان الناموس قد أُعطي بموسى، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد حصلا. الله لم يره أحد قط، الإله، الابن الوحيد الذي في حضن الآب، هو نفسه قد أخبر” (يو 1: 17، 18) ان الناموس الموسوي هو الطريق الذي يقود اليهود إلى الله، أما الطريق الذي يقود المسيحيين إلى الله فهو شخص يسوع المسيح، ابن الله المتجسّد، الذي هو “الطريق والحق والحياة ولا يأتي أحط إلى الآب إلا به” (يو 14: 6). ماذا يعني شخص يسوع المسيح بالنسبة إلى البشر؟ لقد تمّ في شخص يسوع المسيح اتحاد الله والانسان.
فيسوع المسيح هو ابن الله الذي أظهر لنا الإله الحقيقي، وهو الانسان الكامل الذي كان، في عمق كيانه وفي كل حياته، متّحداً اتحاداً تاماً بالله الآب. لذلك حقّق في ذاته وفي حياته حلم الانسان الدائم ببلوغ الاتحاد الكياني بالله. ان المسيحيين، بقبولهم يسوع المسيح واتحادهم به، يكرزون برؤية جديدة للكون وللواقع الانساني.
فالكون الذي يرى فيه كل مؤمن وجه الله الخالق يرون هم فيه أيضاً وجه الله المخلص، بيسوع المسيح الكائن الجديد الذي حقق في الكون الخليقة الجديدة وصالح الانسان مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. نؤمن نحن المسيحيين أن الكيان الانساني قد ظهر في الوجود والتاريخ دون نقص أو اعوجاج في شخص يسوع المسيح الذي، باتحاده العميق بالله في كيانه وحياته، تغلَّبَ على المخرّب والضياع وبلغ كمال الانسانية. ان الكائن الجديد قد ظهر في شخص يسوع المسيح. وهذا الكائن الجديد وحده يطابق جوهر الانسان ما يجب أن يكون. وعلى هذا الإيمان نرتكز لنؤكد أن الانسان يستطيع أن يتغلّب على ما يشعر به من تغرّب وضياع وقلق ويحقّق ما يصبو إليه في عمق كيانه.
فالبشر لا يطلبون جواباً نظرياً على تغرّبهم وقلقهم، بل يطلبون السيطرة على تغرّبهم والخلاص من قلقهم، وهذا ما يجدونه في الاشتراك في الكيان الجديد الذي ظهر في شخص يسوع المسيح.
عندما يعتمدون بالمسيح يلبسون المسيح ويصبحون خلائق جديدة: “أنتم الذين للمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم” (غلا 3: 27)؛ “إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، فالقديم قد اضمحلّ وكلّ شيء قد تجدّد” (2 كور 5: 17). لقد رأينا في الفصل الأول أن هناك ثلاثة أنواع من الخاطر تهدّد الانسان في أبعاد كيانه الثلاثة: فالشعور بالفراغ والعبث يهدّدانه في كيانه الروحي، والشعور بالذنب والهلاك الأبدي يهدّدانه في كيانه الأدبي، والمصائب والموت تهدّده في وجوده وحياته. وقد أظهر لنا يسوع في حياته وأعماله وموته وقيامته انّ من يؤمن بالله ويحيا متّحداً به لا يمكن أن يخاف من بعد أو يقلق إزاء أي من تلك الخاطر. فلا شعور من بعد بالفراغ والعبث عندما نعلم أن لحياتنا قيمة لامتناهية، إذ ان الله أحبّنا إلى حدّ أنه بذل ابنه الوحيد لأجلنا.
ولا شعور من بعد بالذنب ولا خوف من الهلاك الأبدي عندما نعلم أن الله هو إله الرحمة والمغفرة الذي لا يريد موت الخاطئ بل يسعى إليه كالراعي الصالح ليعيد إليه الحياة، وينتظر عودته كما ينتظر الأب الرحيم عودة ابنه الضالّ. ولا خوف من بعد أمام المصائب ولا قلق أمام الموت، عندما نعلم أن الله نفسه يمنحنا قوته لنتغلب على المصائب ونزيل الشرّ من العالم، وننتصر أخيراً على الموت وندخل مع ابنه القائم من بين الأموات إلى الحياة الأبدية. ب- حياة الانسان مع الله يتساءل بعض الناس اليوم: ماذا يفيد الانسان أن يؤمن بالله في عصر الذرّة والعلم والتقنية؟ لقد توصل العلم إلى اكتشاف أسرار الكون وتوصلت التقنية المعاصرة إلى تلبية معظم حاجات الانسان المادية. فما الحاجة بعد إلى الايمان بالله؟
لا يهدف الايمان بالله إلى كشف أسرار الكون للانسان ولا إلى تلبية حاجاته المادية. “نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل”. الإيمان بالله، في المسيحية، هو الإيمان بأن الله هو أب لجميع البشر، وبأن هذا الأب قد أوحى لنا بذاته في شخص ابنه يسوع المسيح ليصبح كل إنسان في المسيح ابناً لله.
الله محبة، والمحبة علاقة بين أشخاص. لذلك فالإيمان بالله هو أولاً الإيمان بأن الله بادرنا بالمحبة وأعطانا ابنه الوحيد ليظهر لنا عمق تلك المحبة ويكون هو نفسه العلاقة بيننا وبين الله، وهو ثانياً الدخول إلى تلك المحبة والحياة بموجبها. وبقدر ما يحيا المسيحي بموجب تلك المحبة، وبقدر ما تتوطّد أواصر العلاقة بينه وبين المسيح، بقدر ذلك ينكشف له الله: “مَن كانت عنده وصاياي وحفظها، يقول يسوع، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبّه أبي، وأنا أُحبّه وأُظهر له ذاتي” (يو 14: 21). لن يظهر الله ذاته للانسان ولن يعرف الانسان الله إلا بقدر ما يحفظ الانسان وصايا الله ويحيا في المحبة. فكما ان المعرفة بين الأشخاص تزيد بقدر ما تزيد محبتهم بعضهم لبعض، كذلك تنمو معرفتنا لله بقدر ما تنمو محبتنا له: “إن أحبّني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبّه، وإليه نأتي، وعنده نجعل مقامنا” (يو 14: 23).
الهدف من الإيمان بالله هو البلوغ بالانسان إلى أن يحيا في ذاته حياة الله، فيقيم الله فيه ويقيم هو في الله. عندئذٍ يسيطر على قلقه وضياعه وتغرّبه، ويجدّد كيانه على صورة المسيح يسوع ابن الله القائل: “أنا في الآب والآب فيَّ” (يو 14: 10).
“إن الله لم يشاهده أحد قط، ولكن إن نحن أحببنا بعضنا بعضاً، أقام الله فينا، وكانت محبته كاملة فينا” (1 يو 4: 12). الله لم يره أحد قط، ولكن من يحيا في المحبة على مثال المسيح وبالاتحاد معه يستطيع أن يختبر الله، ولن نقوى نحن المسيحيين على أن نقود الناس إلى الايمان بالله وإلى اختبار الله في ذواتهم إلا عن طريق المحبة. “إنّ الله محبة. فمن ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه” (1 يو 4: 16).




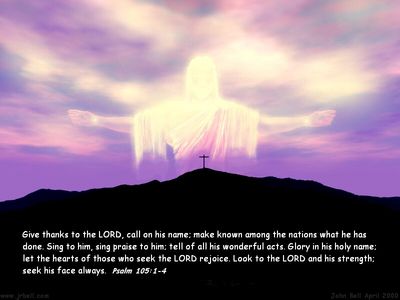
















Discussion about this post